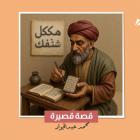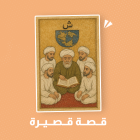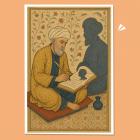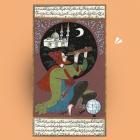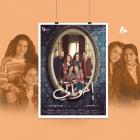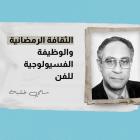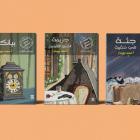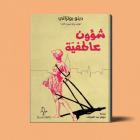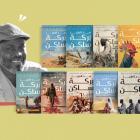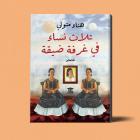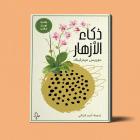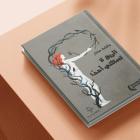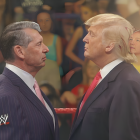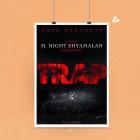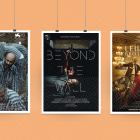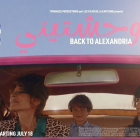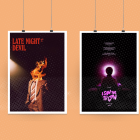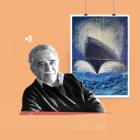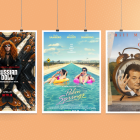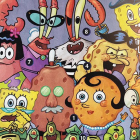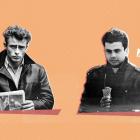فن
هامش من السبل لا تؤدي إلى أي جهة في رحلة «البحث عن سيد مرزوق»
رحلة البحث عن سيد مرزوق: مطاردة السراب، سقوط في التيه، حيث لا يقين إلا التيه ذاته، ولا نهاية إلا بدءٌ آخر.
 المصلق الدعائي لفيلم «البحث عن سيد مرزوق»
المصلق الدعائي لفيلم «البحث عن سيد مرزوق»
لا إله ولا شيطان بل دنيا، لا تبدو في سيد مرزوق ملامح المطلق التي تتميز بها الشخصيات التي يميل البعض إلى ترميزها بإله أو شيطان في الأعمال الفنية منذ إذاعة جوته سر صفقة فاوست الشهيرة مع الشيطان، بل تبدو فيه ملامح الدنيا ورماديتها و«هزارها البايخ»، هذه الدوامة التي نخوضها مُطارِدين تعاقبات الأوهام وخيالاتها، ثم مرتكبين في سبيل الوصول إليها سلسلة معقدة من الحماقات حتى إذا ما أتيناها لم نجدها إلا سرابًا، ثم مُطارَدين من عواقب ما ارتكبنا من حماقات، ثم عودٌ على بدء.
لماذا؟ لا أحد يعلم، هكذا كان التصميم، لعبة!
في أجواء شتوية من ديسمبر عام 1991، ومن تأليف وإخراج الأستاذ داوود عبد السيد وبطولة رائد التجريب الأستاذ نور الشريف، بدأ عرض فيلم «البحث عن سيد مرزوق» بصوت منبه مزعج ومتواصل كبكاء مولود جديد من أثر تجربة الانفصال الأول عن أمه استجابةً لهاتف غيبي يقول:
«الآن، أصبحت مهيئًا لتنزل وتشاهد بنفسك كيف قمنا بكل هذا، وكيف يعمل.»
«الحكاية ابتدت لما صحيت غلط.»
ينزل يوسف متعجلًا للحاق بميعاد الحضور في عمله فيكتشف أنه يوم عطلة، فيقرر أن يقضيه بالخارج، فيقابل ساحرًا ومهرجًا وحكيمًا قبل أن يظهر سيد مرزوق من العدم. وبعد تعارف سريع، كان ملمحه الأظهر انبهار يوسف بأمارات الترف البادية عليه، يستقل بيوسف السيارة في التجلي الأول لنمط سيتكرر خلال الفيلم، وهو الانتقال بالحركة من مستوى لآخر كانتقالات دانتي في الكوميديا الإلهية، وبمجرد الوصول، عُقدت جلسة كيف تحت خيمة بيضاء يجلس تحتها سيد كولي من أولياء الله، ومن حوله تتصاعد أبخرة الحشيش المحترق، مُحثًا يوسف على تعطيل عقله وإطلاق خياله قبل أن يحمل الهواء الدخان إلى المساكين والكادحين ليُقبلوا من كل فج عميق إلى خيمة الكيف المشاع.
يُبشّر سيد في الجلسة من خلال مجموعة من القصص غير المترابطة التي يرويها بالتداعي، متولدةً عن بعضها البعض، بأن الحقيقة نفسها لا تهم، بل الشعور بها، وقدرتك على التصديق وإطلاق الخيال، لا على طرح التساؤلات المملة، فالحقيقة ذاتية لا موضوعية.
وإذا اجتزت بفيلم مشحون بإمكانيات التجاوز مستوى التلقي إلى مستوى التفاعل وخضت تجربة إطلاق الخيال وتعطيل العقل، قد تبدو لك الحقيقة فعلًا ما هي إلا مجموعة الافتراضات التي بدونها لا نستطيع مواصلة الحياة؛ فهي ليست لازمة في وجودها بذاتها بل إرادتنا للحياة ما تجعلها لازمة.
يقول هوميروس عن الحقيقة:
«قل لي الأمر دون التستر عليه في نفسك.»
ومن هذه الزاوية قد نضع فكرة الصراع بين ثنائية «الموضوعية/الذاتية» محل المساءلة والاختبار: فما معنى تمجيد موضوع منفصل عضويًا عن الذات؟ كيف يستطيع الإنسان أن ينزع نفسه من استيعابه وهو مآل مدخلات الوجود بالحواس الداخلية والخارجية ومعالجها بالعقل والشعور والجسد ومستقرها بالذاكرة؟ كيف أعالج موضوعًا وأنا غير موجود؟! فما دمتُ أنا غير موجود فلا شيء موجود!
وعلى العكس، تطرح السيكولوجيا الفردية رؤية أغنى وأكثر ثراءً في تناول قضايا نبالغ عادةً في تقديرها وكأنها مُسيّرة بقوى غريبة نحن غير قادرين على استيضاحها، أعني قضايا مثل المصلحة والسياسة والدين والقوة والسلطة.
فالحياة الإنسانية الباحثة عن سعادتها بالتحصّل على أعلى قدر من المتعة من جهة، وتجنّب أعلى قدر من الألم من جهة ثانية، وعن التلاؤم مع الواقع المحيط من جهة ثالثة، وعن خداع عذابات الضمير - المصنوع على أعين الحضارة ثمنًا للاجتماع الإنساني - من جهة رابعة، تلك النفس تميل إلى تأكيد ذاتها وإنمائها بأشد الأساليب حذرًا وتكيفًا مع الواقع، ما يدفع الإنسان أحيانًا بقوة رغباته كرد فعل إلى الانسياب والتفكك بارتكاب أشد المخاطرات حُمقًا، ما يُشحن الضمير بتحفزٍ مسبق يتشبث بأي مادة ليُمنطقَ ويستعدلَ جلدًا لنفس قد صدر حكمه عليها بلا محاكمة. فلا موضوع منفصل عن الذات الإنسانية الثرية بكل هذا التعقيد، فهذه الثنائية خطأ تأسيسي، لكنه ليس طارئًا بل هو الخطأ المفهوم، القادر على تسميم التجربة الفكرية بمحاولات حوكمة ومأسسة الجموع البشرية بفرض رؤية تُنفي وجود الإنسان ذاته.
وفي ثنايا موسيقى الموسيقار راجح داوود، وما تشيعه من غيوم على الأحداث، يتداخل الواقع في الفيلم كثيرًا مع الحلم، وإن كان الحلم أيضًا واقعًا قد عالجته النفس من زاوية مختلفة، فأعادت صياغته بعد تحييد قيود الزمان والمكان والمنطق وتشفير بيانات الذاكرة، طارَدَت فيه الشرطة يوسفَ بلا سبب ظاهر، فهرب منها ليرى نفسه خارج نفسه مع سيد وبجواره تغني لوسي «يا حلاوة الدنيا» على أنغام رديئة للأستاذ أنور العوّاد، الذي يُشبه أحد رؤساء مصر السابقين في «نكشة» يجيدها الأستاذ داوود عبد السيد.
وعند هذه النقطة لا تعرف على وجه الدقة: هل حِلم يوسف بسيد ولوسي وحلاوة الدنيا هو الحلم بعد واقع مطاردة الشرطة، أم مطاردة الشرطة هي الحلم وحلاوة الدنيا هي الواقع؟
فبما أننا نحلم كثيرًا، ما من شيء يضمن أن ما نطلق عليه اسم الحياة ليس كليًا سوى حلم لا نستفيق منه إلا بالموت.
يُحكى عن الفيلسوف الصيني تشوانج تسو أنه رأى في الحلم أنه فراشة، وعندما استيقظ وجد نفسه أنه ما زال تشوانج السمين، فأصبح لا يدري: هل تشوانج السمين هو مَن حلم أنه فراشة، أم الفراشة هي ما تحلم الآن أنها تشوانج السمين!
المساحة الواقعة بين الخوف والرجاء هي مسرح ملائم لخلق وتشكيل السراب، فلا معنى للسير في تيه الصحراء إلا لو رأيت الماء، ولو كان سرابًا.
وظواهر العالم المادي قد تكون مجرد رمز للتجرِبة الذاتية، فعند مشاهدة الأمواج وصخبها وشدة اندفاعها للشاطئ كأنها ملهوفة، أشد اللهفة، على شيء ما، تريد أن تسبق الجميع حتى الهواء نفسه، وما أن تصل حتى تعود خائبة محبطة، تشعر كأن الأمواج كلها أنت!
تدور أحداث الفيلم كله في ليلة واحدة لو سُئل عنها يوسف لقال: ألف سنة مما تعدون. وهذا نمط متكرر عند المخرج المصري داوود عبد السيد، ألا وهو نمط دخول الشخصية إلى عالم مختلف عن عالمها نتيجة قرار عادةً ما يكون عشوائيًا وغير مدروس، وأقرب لمسارات اليأس على المستوى السطحي.
أما فيما بعد هذا المستوى فهناك شحنات كمية صغيرة تكاد لا تُرى تتراكم في نفس الشخصية حتى تصل به إلى نقطة التحول الكيفي، كأن كل شيء في حياته كان يؤهله بلا وعي لاتخاذ هذا القرار في هذا الوقت بالتحديد. فتغير الذات الإنسانية يبدأ بالاستعداد، والاستعداد يكون بالتهيؤ لاستقبال الحوادث وتمكينها من ترك أثرها في النفس، والنفس لا تتغير بأمر خارجي عنها، بل بأثر هذا الأمر فيها. وقرار التهيؤ لاستقبال التجربة كان بالاعتراف بحب سيد مرزوق، هذا القرار الذي ألقى بيوسف فجأة إلى الهاوية التي كانت تحدق إليه طوال عمره، ويتجسد هذا القرار بصريًا في تعبيرات وجه نور الشريف التي تتجرد إلا من الانفعالات الشعورية الحادة.
وتستمر الشحنة الشعورية في التراكم حتى نشاهد في النهاية شخصية قد تغيرت تمامًا، أي انتفى عنها ما كان حاصلًا، وحصل ما كان منتفيًا، وهذا ليس بغريب عن طباع البشر، فالأحداث والوقائع تُنبئنا دومًا بأن نفوس الناس تتغير بشكل لا يمكن التنبؤ به.
وأحداث الفيلم كله تقيم في اللحظة الحاضرة التي لا تُشبعُ أبدًا بعاطفة واحدة أو بحالة نفسية واحدة أو بفعل إرادي واحد، بل إنها وحدة من التنوع. وكل لحظة تملك معناها في ذاتها لأنها قادرة على التنامي حتى تصل إلى تقرير مصيرنا بشكل مطلق، فهي المجاز للخلود الإلهي لا الماضي ولا المستقبل.
تطرح حنة آرنت فكرة أن الإسقاط الثلاثي لفكرة الزمن بين ماضٍ وحاضر ومستقبل يرتكز على التقويم — المرتكز على لحظة ميلاد المسيح كنقطة انطلاق زمنية — لا الزمن، نقطة انطلاق يغرق فيها الماضي في البعيد اللانهائي والمستقبل في البعيد اللانهائي الآخر، وهذه اللانهائية من الجانبين تُلغي من الأصل فكرة البداية والنهاية، وتجعل الإنسان مخلدًا في صُلب اللحظة الحاضرة، ومنبع شرود يوسف أنه قد أقام فجأة في نقطة خلود حاضرة تقع بين غيابين.
وبمشاهد متعاقبة لحركة كاميرا سريعة تنتقل من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن حالة إلى حالة بشكل مفاجئ وغير مبرر، كالدنيا، تتحفظ الشرطة على يوسف بعدما قيدوه بكرسي حمل حمله أنى راح وغدى، ثم أصبح وسط تبادل لإطلاق نار رفع في خضمه الراية البيضاء دون أن يكون طرفًا فيه، ورغم ذلك كان هو المصاب الوحيد.
ثم عُممت الإشارة على كل المستشفيات بالقبض على أي جريح والتعامل معه باعتباره مسلحًا خطرًا! ولا أحد يعلم لماذا، ولا حتى هو نفسه، كأنها أعراض جانبية لتجربة الحياة، كسيزيف.
عنصر الحوار من أظهر عناصر الإبداع في العمل، إذ تُشحن الجمل الحوارية من المعاني بما ينقلها إلى مستويات أعمق بعيدًا عن المستوى الحرفي الأول من الاستقبال والتلقي.
«اقعد، ضم صوابعك، لأ ضم صوابعك مش إيدك، بس خلاص، انت حر!»
هكذا! بكل بساطة فُك قيده بكرسي سيزيف دون مساعدة من أحد، كأنه قيد ذهني أو نفسي.
«البوليس بيدور على واحد مجروح برصاص، ماتسألنيش بقولك ليه!»
والأوقع أن تقول: ماتسألنيش بقولك إيه!
قُبض عليه لأنه مجروح، فيسأل الضابط:
ــ هو الجرح بقى تهمة؟
* أيوة يا شاطر، ورد عليا كويس!
ذهب به الضابط إلى منزله مُصرًا على أن ينام، مجددًا:
«تقدر تفكر وماتحزنش؟»
تبدو الحياة في مستواها السطحي قابلة للعيش، ولكن إن تجاوزته لمستوى واحد فقط ستقترب من بُعدٍ ما في نفسك، وإذا اقتربت من نفسك ستحزن.
«يا يوسف متسألش ليه، الدنيا مابتتعرفش بالأسئلة.»
يضيق العارفون بالأسئلة ذرعًا، وقد ضاق الخضر بموسى وفارقه لنفس السبب. لماذا؟ هذا سؤال أيضًا لو قلته لفارقني، لكنه — ولحسن الحظ — كان يُجيب على الأسئلة كلها قبل الفراق.
وجد نفسه متهمًا بجريمة قتل! لم يقصد يوسف أيًا مما حدث، ولم يسعَ إليه، بل وجد نفسه — وإن كان هذا أيضًا ليس التعبير الأدق — بل أقول: اتجهت به نفسه هذه الوجهة بلا وعي حتى وجدها هناك، وما بين «أنا بحب سيد مرزوق» إلى «هقتلك يا سيد يا مرزوق» دنيا، مأساة بلا داعٍ.
وقع من السلم فغاب عن الوعي، فنام، الزمن يختل في كل مستوى وكذلك الرؤية. أمسى فجأة في شقة سليمان الحكيم، الذي حوّل غرفة فيها إلى حَضّانة تؤوي صغيرته التي لم يجد ما يكفي من المال كي يذهب بها إلى مستشفى.
يقول يوسف:
«حسيت بقوة غريبة ورغبة في التحرر، محتار، عارف ليه؟ إزاي أرجع لحياتي الأولانية بعد كل ده؟»
وتقول أروى صالح:
«لقد مسّه سحر الحلم مرة، وستبقى تلاحقه دومًا ذكرى الخطيئة الجميلة — لحظة حرية، خفة لا تكاد تحتمل لفرط جمالها — تبقى مؤرقة كالضمير.»
ويقول أهل الكشف والإشراق:
«ومَن ذاق عرف.»
رد سليمان:
«السجن اللي كرهته حماية لينا، وانت جوه حدودك بتحافظ على نفسك زي الحيوان البري جوه القوقعة.»
جدل الحرية والأمن: هل متعارضان؟ هل نقبل بهذا أم نعيد صياغته فنقول إن الحرية مرتبطة بمسؤولية جديرة بأن تتحملها وحدك، وألا تشيح بوجهك عن المرآة، قارئًا كتابًا سيُكتفى بشأنه بنفسك يومًا ما عليك حسيبًا؟ اختر ما تشاء، فاللغة أيضًا ليست على هذا المستوى من الإطلاق، بل يُشكّلها وعي الإنسان بنشاطه ووجهته.
دخل إلى غرفة الصغيرة المعقمة وهو غير معقم، وهذا حكمٌ عليها بالقتل. وبمجرد أن رمى نفسه من الشباك غرق في مستودع أقذار داخل صفيحة قمامة، فغاب عن الوعي. فألقوه في عربة القمامة كجزء منها، وساروا. وأفاق وسط أكوام منها تحترق بنار حوله من كل جانب. هل ذهب إلى الجحيم؟
سقط مغشيًا عليه، سابعًا، ترقّى سبعة مدارك أو تدنّى سبعة، كالسماوات والأرضين، وكلاهما مستقر ومستودع. وجدوه ملقى على الرصيف، فألقوه في النيل قبل أن تلتقطه الضفادع البشرية كما تلتقط الدمى من القاع. هل أصبح هو نفسه دمية تتلاعب بها شطحات الرغبة، وتجنب الآلام، وقمع الضمير، وسطوة الواقع؟
دخل قهوةً أقرب إلى ملجأ تلتئم في أركانه جراح البائسين والمشردين، قبل أن يهرب يوسف منها متنكّرًا في زي مهرج ليخرج إلى هامش من السبل لا تؤدي إلى أي جهة.
وحتى بعدما حاول يوسف قتله، سيد مرزوق لا يموت. أصبح قصره موحشًا كقصر الجبلاوي في حارة نجيب محفوظ، قد تكون الوحدة هي السبب في كل هذه المأساة!
في فيلم «البحث عن سيد مرزوق» يتجلّى التمرد الأصيل للفن على النزعة المحافظة لدى العلم؛ فالعلم قائم على التراكم، وثبات الحفاظ على الحقائق المثبتة في حدودها التقريبية، أما الفن فتعددٌ مطلق، إذ يبدأ الفنان عمله وكأنه يكتشف العالم لأول مرة، وكلما اقترب الفنان من النفس البشرية، كلما اقترب فنه من شكل من أشكال البدائية، وزادت قدرته على خلق الدهشة المرتبطة بالإبداع والكشف.